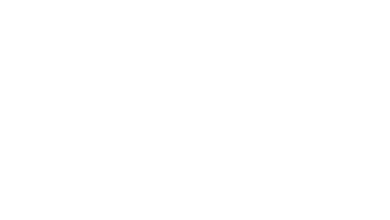الرصد
السياسة الخارجية الأميركية في عالمٍ أكثر صعوبةً واضطراباً

جيسيكا تاكمان ماثيوز
المعايير وحتى المعتقدات الأساسية للسلوكيات الدولية، كانت مُبعثرة يمنة ويساراً طيلة السنوات الأخيرة: قيام “غرباء خضر صغار” من الفضاء تابعين لفلاديمير بوتين بضمّ شبه جزيرة القرم، ثم غزو بوتين السرّي لأوكرانيا على يد جنود روس كانوا “في إجازة” مع دباباتهم؛ الدمج الذي أقدم عليه تنظيم الدولة الإسلامية بين العادات القروسطية وبين التقنيات الحديثة لممارسة الحُكم كما للقتال؛ قيام الصين بين الفينة والأخرى باستفزازات في شرق وجنوب بحر الصين؛ وأخيراً، في سورية، هدم دولة كانت فاعلة حتى الآونة الأخيرة، من دون أن يكون العالم قادراً على وقف الدمار الإنساني والمادي.
اللائمة أُلقيت أساساً على عاتق الولايات المتحدة، لكن في الواقع ثمة ماهو أكثر بكثير وراء ماحدث، أي أكثر من مجرد ارتكاب الولايات المتحدة أخطاء تكتيكية، أو لعدم استعدادها نشر قوات برية في جبهات القتال الجديدة.
إبّان الحرب الباردة، كان دور الولايات المتحدة واضحاً وجليا: تزعُّم المعركة ضد الاتحاد السوفييتي والشيوعية في أرجاء العالم. صحيح أن القرارات الفردية لم تكن واضحة، وغالباً ماكان ثمة توترات مؤلمة بين الهدف ذي الأولوية الكبرى وبين القيم الأميركية، إلا أنه من الصحيح أيضاً أن الأميركيين عموماً تشاطروا التزاماً لما فهموا أنه هدف بلادهم الضروري في الخارج.
لكن، مع انهيار الاتحاد السوفييتي تبدّد هذا الغموض. ومنذ ذلك الحين، تخبّط الأميركيون وتعثّروا في لجج الارتباك: هل هدفنا هو تعظيم القوة الأميركية أم نشر ثقافتنا الديمقراطية؟ هل يتعيّن على الولايات المتحدة أن تكون شرطي العالم، حتى ولو لم نكن عُرضة مباشرة إلى الخطر؟ هل يجب أن نبقى داخل حدود بلادنا ونركّز على معالجة شوائبنا، أم نشعر أننا مُجبَرون على تنظيم العالم في إطار رأسمالية السوق الحرة؟
النقاش يمكن صوغه بمصطلحات تغيير النظام في مقابل بناء الأمة، أو القانون الدولي في مواجهة الاستثنائية، أو الانفرادية في وجه التعدّدية، أو المصالح في مقابل القيم. لكن خلف هذه المصطلحات المتباينة يكمن البحث نفسه عن مرشد أو إطار لتقرير متى وأين نزج المال، والدم، والرأسمال السياسي. من دون هذا الإطار، كما تُظهِر استطلاعات الرأي، لايتمتّع الشعب الأميركي بالوضوح أكثر من قادته حول متى يجب على الولايات المتحدة أن تعمل، ومتى يجب ألا تعمل. كما أن الشعب مثل هؤلاء القادة عُرضة إلى تغيير مواقفه بشكل جذري مع تطوّر الأحداث.
وفي هذه الأثناء، أصبح العالم أكثر صعوبة بكثير. أصبح مكاناً مضطربا. فكل ملياراته السبعة تقريباً تعيش الآن في سوق واحدة. وشروط معاهدة وستفاليا بأنّ مايحدث داخل حدود دولة لايعني أي طرف آخر، تبدّدت هباءً منثورا. الحدود الآن باتت سهلة الاختراق بالنسبة إلى الناس، والجريمة، والمعلومات، والمال، والأسلحة، والتلوث، والأوبئة. وفي مثل هذه الحالة من الاضطراب، يصبح غياب عنوان متّفق عليه في السياسة الخارجية لتعريف دور الولايات المتحدة، أكثر حدّة وحساسية.
جدير بالذكر هنا أن الولايات المتحدة ليست وحدها في هذا الأمر. فالصين أيضاً تبدو متناقضة – وحتى فصامية – حول دورها. لقد تخلّت عن مبدأ دنغ هسياو بنغ بأن عليها أن تبقى في مواقع خفيضة، وهي تراكم قوتها الاقتصادية. هذا واضح: فالعالم لم يَعُد يسمع عن “الصعود السلمي” للصين. لكن ثمة شكوكاً كثيفة أيضا، بما في ذلك في الصين على مايبدو، حول مدى وآفاق نواياها. فبناؤها العسكري يجري بسرعة (وإن انطلاقاً من قاعدة منخفضة). وسلوكياتها في شرق وجنوب بحر الصين حول الجزر الصغيرة المتنازَع عليها كانت استفزازيةً بما فيه الكفاية لإشعال القلق في طول المنطقة وعرضها. والأكثر إقلاقاً هو أن الصين تطلب أحياناً أن تُعامَل كدولة كبرى مع كل الحقوق التي يتضمّنها ذلك (ولكن ليس المسؤوليات). وفي مناسبات أخرى، وفي السياق المجازي نفسه تقريبا، تتلبّس الصين دور الدولة التي لاتزال ضعيفة وفقيرة (على أساس دخل الفرد) وضحية التجاوزات الاستعمارية. هذان السلوكان يخلقان مزيجاً ساما.
الهند عليها مواجهة مخاطر تنطلق من جيرانها – باكستان والصين – ومهمات ضخمة في الوطن تتعلّق بإصلاح حكومةٍ تغذّي الفساد وتشلّ النمو الاقتصادي. واليابان، التي لاتزال غير قادرة بشكل مذهل على الاعتذار عن سلوكيات شائنة وبغيضة إبّان الحرب العالمية الثانية، تستثير قومية غاضبة في الصين. وهذا بدوره يغذّي الجناح اليميني فيها ومعه النقاش المتصاعد حول وضعية اليابان العسكرية.
وفي الشرق الأوسط، يبدو أن إسرائيل تخلّت عن السلام، واستقرّت على سياسة عراك ومجابهات تقود إلى طريق مسدود، سياسة من شأـنها أن تجعل من المستحيل تحقيق حلّ الدولتين أو الدولة الواحدة المستقرة. وهذا من دون توفُّر أي بديل واضح.
إيران تقترب مما قد يكون اتفاقيةً مهمةً تاريخياً لتبديد قلق العالم من برنامجها النووي. لكنها هي أيضاً ممزّقة. فهي قد تقرّر، كما أوضح كريم سادجادبور من كارنيغي، أن تضع مصالح ثورتها الإسلامية قبل مصالح الأمة الإيرانية، وتقوّض بالتالي الصفقة النهائية. (الكونغرس الأميركي قد يجعل الخيارات الصعبة أمام إيران غير ضرورية، من خلال فرض عقوبات سابقة لأوانها حول فشلها في تلبية الموعد النهائي للمفاوضات، وهو حينئذ سيخدم مباشرة الحرس الثوري وبقية السرب اليميني الإيراني الذين يفيدون من عزلة البلاد، ويكرّس قناعة المرشد الأعلى بأن الولايات المتحدة أرادت دوماً تغيير النظام).
أما العالم العربي فهو يعجّ بالصراعات الطائفية التي ستستهلك وتحدد مستقبله المنظور. ومن جهتها، السعودية ودول الخليج الصغيرة لم تستطع بعد حزم أمرها حول أي من الكابوسين المتنافسين هو الأقل ضررا: ذاك الذي يشير إلى أن الولايات المتحدة ستُبرِم صفقة مع إيران، أو أن المفاوضات ستفشل وإيران ستصبح دولة نووية.
وحدها أوروبا من بين القوى الكبرى لاتُبدي ارتباكاً إزاء دورها الدولي. فهي لاشك واضحة تماماً في مايتعلّق بقيمها، وبمكمَن نقاط قوّتها المقارَنة في الشؤون الدولية. إلا أن أوروبا ككلّ لم تواجه بعد حاجتها إلى الاضطلاع، في نهاية المطاف، بدورٍ استراتيجيٍّ أكبر في ضمان أمنها الخاص وأمن المنطقة والبلدان الأبعد. فهي لاتزال منغمسةً في مشروع وحدتها الواسع، إلى حدّ أنه لم يبقَ إلا طاقة ضئيلة لديها على التعامل مع العالم الواقع خارج حدودها.
وهذا يقودنا مجدداً إلى معضلة بوتين. فمنذ ثلاث سنوات، صُدِم بوتين وتضعضعت شرعيته بشدة بفعل التظاهرات الواسعة ضد حكومته. وفي العام 2012، وأملاً في تحويل الأنظار في الخارج، كما يفعل الزعماء المجروحون، نفّذ استدارته نحو آسيا، مديراً ظهره للغرب بتعجرف. فردّت الولايات المتحدة وأوروبا بمعظمها من خلال التعالي رسمياً على الألعاب الأولمبية في سوتشي، التي كان بوتين قد جعلها مهمّتَه الخاصة، ولم يبخل بالإنفاق عليها.
روسيا تنوي منع جورجيا أو أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مهما كلّف الأمر، وهي تعتبر أن الارتباط بالاتحاد الأوروبي المؤدّي إلى الانضمام إليه ثم إلى الناتو، هو امتداد لمنزلقٍ واحد. لكن كان ثمة وسائل أخرى لتحقيق هذه الغاية. إذ أن تفكيك لغز خطة بوتين على المدى الطويل، إن وُجِدَت فعلاً، لاجتياح شبه جزيرة القرم وضمّها، ثم إرسال الأسلحة، والمقاتلين، والجنود الروس في نهاية المطاف، إلى شرق أوكرانيا، هو مجرّد تخمين إلى حدٍّ كبير. صحيح أن العمليات في أوكرانيا أكسبته شعبيةَ رئيسٍ في زمن الحرب، إلا أن روسيا تدفن جنودها القتلى في جنح الظلام، فيما التكاليف الاقتصادية للعقوبات المفروضة عليها باهظة وترتفع بشكل حاد. لقد أساء بوتين إلى حدٍّ كبير تقدير الوحدة الغربية، ولاسيما صلابة قيادة أنجيلا ميركل. ثم أن موقع روسيا الطبيعي، على المدى البعيد، هو في أوروبا لا في آسيا.
لذا، في العام 2015، ستشاطر قوى عدة الولايات المتحدة حيرتَها في مايتعلّق بسياستها الخارجية ومصالحها الرئيسة. فثمة أخطاء سابقة عدة لايمكن إصلاحها، ولذلك لايبقى سوى المضي قدماً بخيارات محدودة. إن الأجندة هائلة، لكن التحرّك ضروري في مجالات أربعة هي إيران وسورية وروسيا والصين.
والأهم من ذلك أن الولايات المتحدة ينبغي أن تواصل بذل كل ما في وسعها بغية التوصّل إلى اتفاق نووي معقول مع إيران (كما فعلت الإدارة حتى الآن). وهذا يعني أن الكونغرس، ولما فيه مصلحة البلاد، يجب أن يمتنع عن شهر سلاح العقوبات إلى أن تفشل المفاوضات أو تستأنف إيران أنشطتها النووية التي كانت علّقتها.
لم يَعُد بمقدور الرئيس أوباما الاستمرار في ازدواجيته حيال مصير الرئيس السوري بشار الأسد. لابد أن يتّخذ خياراً واضحاً ويقرّ بالثغرة الفاقعة في سياسته الحالية، التي ببساطة لاتوفّر قوة مناسبة على الأرض لمقاتلة الدولة الإسلامية في سورية. إذا لم يحصل ذلك، ستصبح سورية ملاذاً لهذه الجماعة، وهذه تضحية غير مرغوب فيها لنجاح العمليات العسكرية ضد الجهاديين في العراق.
كما لايجوز أن يسمح أوباما باستمرار العلاقات الأميركية مع روسيا في حالتها الراهنة المجمَّدة، حيث لا أحد على المستوى الرفيع يبدو قادراً على إعادة بناء علاقات فاعلة أو مهتمّاً في إحيائها.
أخيراً، يتعيّن على الولايات المتحدة أن تطبّق سياستها المعلنة المتعلّقة بإعادة التوازن نحو آسيا. فالرسالة التي تلقّفتها بكين مما سمّي بالاستدارة، هي أن واشنطن صمّمت سياسةً لاحتواء الصين. وواقعُ أنّ الولايات المتحدة لم تفعل شيئاً لتطبيق هذه السياسة، لم يكن مدعاةً للاطمئنان بل للارتباك. فإعادة التوازن من دون فحوى هي سياسة خاسرة تدفع بكين إلى أن تخشى الأسوأ، ناهيك عن أنها لاتعزّز مصالح الولايات المتحدة.
بعد عام من اليوم سنرى على الأرجح أن أبرز تطوّر في العام 2015 لم يكن أياً مما ذكرنا أعلاه. فإذا استقرّت أسعار النفط على 60 دولاراً للبرميل، كما يبدو الآن محتملاً جدا، أي أقل من نصف القيمة القصوى التي بلغتها مؤخرا، فسيؤدّي ذلك إلى تغيير قواعد اللعبة عالميا. إذ أن الاقتصادات والعلاقات الاقتصادية جميعها تقريباً لن تسلَم من ذلك. ثمة مايكفي من الفرص الإيجابية – الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية – التي ستُتاح لبضع سنوات إذا مابقيت الأسعار على حالها تقريبا. وتحديد هذه الفرص واغتنامها هما الأولوية القصوى الجديدة لصانعي السياسات في كل مكان.
نقلاً عن موقع مركز كارنيغي