الاكثر قراءةتحليلات و آراءغير مصنف
شد الحبل على ضفاف البوتوماك: الكونغرس والرئاسة وصناعة السياسة الخارجية
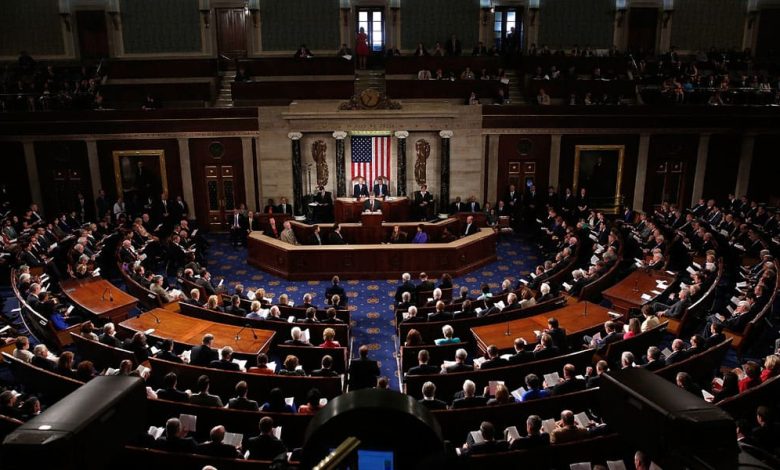
بقلم: الباحث محمد مكي الطاهر
السودان
يقوم هيكل النظام السياسي الأمريكي على مبدأ الفصل بين السلطات، وهو نظام صممه الآباء المؤسسون بدقة لضمان عدم انفراد أي طرف بالسلطة المطلقة. يتجلى هذا التوازن بشكل واضح في إدارة الشؤون الخارجية، حيث منح الدستور كلاً من الكونغرس والرئيس أدواراً متداخلة تفرض نوعاً من التعاون القسري. فبينما يتمتع الرئيس بصفة القائد الأعلى للقوات المسلحة وكبير الدبلوماسيين، يحتفظ الكونغرس بصلاحيات جوهرية تشمل إعلان الحرب، وإقرار الميزانيات العسكرية، والمصادقة على المعاهدات الدولية. هذا التوزيع المتعمد للصلاحيات لم يضع حدوداً فاصلة وواضحة، بل خلق حالة دائمة من التوتر وُصفت بأنها “دعوة للصراع” حول قيادة السياسة الخارجية للبلاد.
لم يحدد الدستور بدقة كيفية التعامل مع كافة مواقف السياسة الخارجية، مما أوجد “مناطق رمادية” أصبحت ساحة للصراع بين السلطتين. على سبيل المثال، تمنح المادة الأولى للكونغرس سلطة حصرية في إعلان الحرب و”سلطة المال” عبر تخصيص ميزانيات الجيش. في المقابل، تمنح المادة الثانية الرئيس سلطة تنفيذية شاملة لإدارة الشؤون اليومية واستقبال السفراء، وهي سلطة فُسرت على أنها تمنحه الأفضلية في الاستجابة السريعة للأزمات الدولية.
هذا التداخل يثير تساؤلات مستمرة حول شرعية إرسال القوات للخارج دون إعلان حرب رسمي، أو لجوء الرؤساء إلى “الاتفاقيات التنفيذية” للالتفاف على شرط موافقة مجلس الشيوخ على المعاهدات.
منذ منتصف القرن العشرين، بدأ التوازن يميل بشكل بنيوي لصالح البيت الأبيض نتيجة الأزمات الدولية المتلاحقة، بدءاً من الحروب العالمية وصولاً إلى الحرب الباردة. خلال هذه الفترات، اعتاد المشرعون تفويض سلطات واسعة للرئيس للتعامل مع التهديدات، مما خلق سوابق تاريخية عززت مكانة الرئيس كمتحدث وحيد باسم الأمة. وقد بلغ هذا التوجه ذروته خلال حرب فيتنام، حيث وسعت الإدارات الأمريكية تدخلها العسكري دون غطاء دستوري واضح، مما دفع المؤرخين لصك مصطلح “الرئاسة الإمبراطورية” لوصف السلطة شبه المطلقة التي بات يتمتع بها الرئيس في الشؤون العسكرية والخارجية.
كرد فعل على تجاوزات عهد فيتنام، مرر الكونغرس “قانون صلاحيات الحرب” عام 1973 بهدف تقييد قدرة الرئيس على شن حروب دون موافقته. يفرض القانون على الرئيس التشاور مع المشرعين، وتقديم تقارير خلال 48 ساعة من نشر القوات، مع سحبها خلال 60 يوماً ما لم يوافق الكونغرس على التمديد. ومع ذلك، ظلت فعالية هذا القانون محل جدل، إذ تحايل عليه الرؤساء من كلا الحزبين، معتبرين إياه تدخلاً غير دستوري. وتفاقم هذا الوضع بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، حيث مُنح الرئيس تفويضاً واسعاً لاستخدام القوة العسكرية، استُخدم لاحقاً لتبرير عمليات في أكثر من 20 دولة، مما حول أداة مواجهة الإرهاب إلى أساس لـ “حرب عالمية دائمة” عززت هيمنة الرئاسة في العصر الحديث.
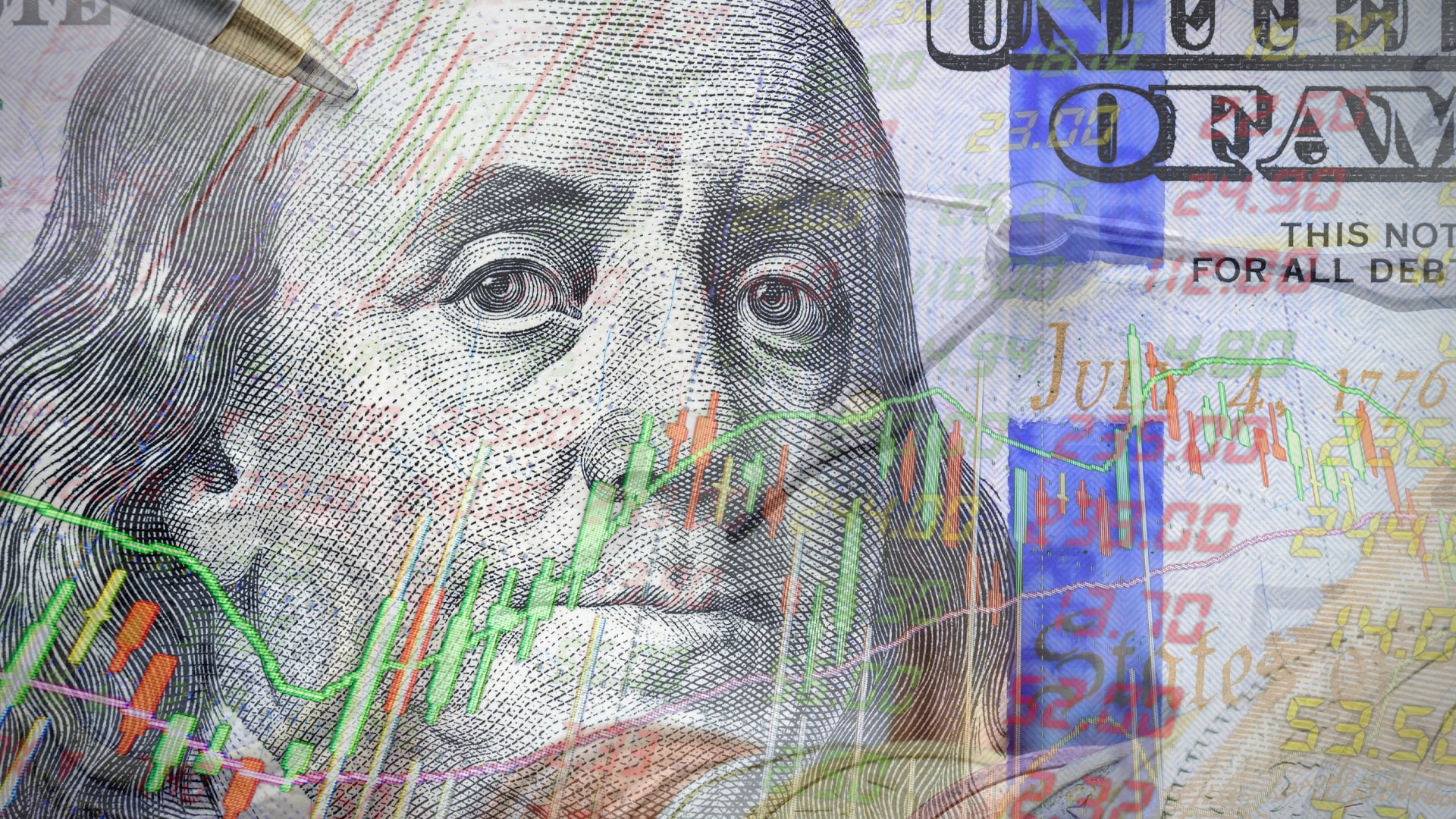
تُعد “سلطة المال” الأداة الأكثر قوة وتأثيراً التي منحها الدستور الأمريكي للكونغرس، حيث تنص المادة الأولى صراحةً على أنه لا يجوز سحب أي أموال من الخزانة إلا بناءً على مخصصات يحددها القانون. تمنح هذه السلطة المشرعين القدرة الحصرية على “فتح أو إغلاق صنبور الأموال”، مما يجبر الرئيس على تبرير سياساته للحصول على التمويل اللازم لعملياته العسكرية أو برامج المساعدات الخارجية. ورغم أن استخدام هذه الأداة لإنهاء الحروب يُعد أمراً نادراً، إلا أن التاريخ يسجل نجاح الكونغرس في عام 1973 في تمرير تعديل “كيس- تشيرش” الذي حظر تمويل الأنشطة العسكرية في فيتنام ولاوس وكمبوديا، وهو الإجراء الذي كان حاسماً في إنهاء التدخل العسكري المباشر رغم معارضة السلطة التنفيذية.
في العقد الأخير، تحولت حرب اليمن إلى ساحة اختبار معاصرة لهذه السلطة المالية، حيث سعى تحالف من المشرعين من كلا الحزبين منذ عام 2015 إلى تقييد الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية. وقد تجلى هذا الصراع في تمرير قرار مشترك عام 2019 يطالب بإنهاء الدعم العسكري، ورغم استخدام الرئيس ترامب حق الفيتو لتعطيله، إلا أن الخطوة كشفت عن وجود أغلبية برلمانية تعارض سياسة الإدارة. كما استخدم الكونغرس “قانون مراقبة تصدير الأسلحة” لعرقلة صفقات الأسلحة الكبرى، مما أدى إلى تأخيرها وزيادة الشفافية حولها، ودفع إدارة بايدن في نهاية المطاف إلى تعديل مسارها بإعلان إنهاء الدعم للعمليات الهجومية وتجميد بعض الصفقات مؤقتاً.
إلى جانب الأدوات المالية، يمارس الكونغرس سلطة رقابية واسعة تُعتبر سلطة ضمنية ضرورية لعملية التشريع المستنير ومساءلة السلطة التنفيذية. وتُنفذ هذه الرقابة عبر لجان متخصصة تملك صلاحية استدعاء كبار المسؤولين، من وزراء الدفاع والخارجية إلى الجنرالات، للإدلاء بشهاداتهم تحت القسم. ورغم أن هذه الجلسات لا تغير السياسات فوراً، إلا أنها تفرض الشفافية، وتؤثر في الرأي العام، وتبني أساساً لتشريعات مستقبلية تهدف إلى تقييد تحركات الإدارة.
ويبرز التحقيق في الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2021 كمثال صارخ على هذه القوة الرقابية، حيث واجهت إدارة بايدن انتقادات حادة وجلسات استماع مكثفة لكبار قادتها العسكريين والدبلوماسيين. وقد تصاعدت المواجهة مع مطالبة المشرعين بالحصول على وثائق حساسة، مثل “برقيات المعارضة” التي حذرت من انهيار وشيك قبل وقوع الكارثة. ورغم أن الإدارة استندت إلى “الامتياز التنفيذي” لمقاومة بعض هذه الطلبات، إلا أن التحقيقات نجحت في تسليط الضوء على إخفاقات الإدارة وفرضت عليها تقديم إجابات علنية أمام الجمهور، مما يثبت أن الرقابة أداة قوية للمساءلة بأثر رجعي وإن كانت أضعف في تغيير الأحداث في وقتها الفعلي.
تجلت قدرة الكونغرس على ابتكار أدوات قانونية جديدة لمواجهة انفراد البيت الأبيض بالقرار في حالة “خطة العمل الشاملة المشتركة” (الاتفاق النووي الإيراني). فبسبب صعوبة تمرير الاتفاق كمعاهدة رسمية تتطلب موافقة ثلثي مجلس الشيوخ، لجأت إدارة أوباما إلى صيغة “الاتفاق التنفيذي” لتجاوز المشرعين. ورداً على ذلك، فرض الكونغرس “قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني” (INARA) عام 2015، وهو تشريع ألزم الإدارة بتقديم نص الاتفاق كاملاً للمراجعة، ومنح المشرعين نافذة زمنية لرفضه أو قبوله. وعلى الرغم من أن هذا القانون لم يمنع الاتفاق في النهاية، إلا أنه حوّل الكونغرس من مراقب هامشي إلى شريك إجباري، مما أثبت أن المؤسسة التشريعية قادرة على “إدخال نفسها” في أعقد ملفات السياسة الخارجية عبر الابتكار القانوني.
ومع ذلك، تظل فعالية هذه الأدوات رهينة الحسابات السياسية والواقع الحزبي؛ فالاستقطاب الحاد في واشنطن غالباً ما يجعل الصراع يبدو وكأنه مناكفة بين الأحزاب وليس دفاعاً عن صلاحيات المؤسسة. إن قدرة الكونغرس على كبح جماح الإدارة تضعف عندما يغلب الولاء الحزبي على الدور الرقابي، مما يترك الساحة للبيت الأبيض لقيادة دفة التوجهات الدولية للبلاد دون ممانعة حقيقية.
في الختام، يتضح أن الجدل حول “الرئاسة الإمبراطورية” ليس سوى جزء من صورة أكبر تتعلق بطبيعة السياسة الخارجية الأمريكية ككل. فبصرف النظر عن المؤسسة التي تقود القرار، أثبتت الوقائع- من التدخل في اليمن إلى الانسحاب من أفغانستان- أن جوهر هذه السياسة يتسم بنزعة دائمة نحو التدخل والهيمنة في الشؤون الدولية. إن “شد الحبل” المستمر بين الكونغرس والبيت الأبيض لا يعبر دائماً عن اختلاف في الأهداف الاستراتيجية الكبرى، بل غالباً ما يكون صراعاً على آلية التنفيذ ومن يمتلك الكلمة الأخيرة في إدارة النفوذ الأمريكي حول العالم.
إن تآكل دور الكونغرس ليس مجرد خلل دستوري، بل هو انعكاس لبيئة سياسية تمنح الأولوية للسرعة والحسم في “الحرب العالمية على الإرهـ ــاب” وما تلاها من أزمات، مما عزز قبضة السلطة التنفيذية. ومع ذلك، تظل الأدوات التي استعرضها البحث سواء المالية أو الرقابية أو التشريعية هي “الأنياب” التي يحاول من خلالها المشرعون فرض نوع من الشفافية والمساءلة على قرارات قد تؤدي إلى تدخلات عسكرية كبرى. في نهاية المطاف، يبقى التوازن بين هذه المؤسسات ضمانة داخلية لإدارة الصراع، لكنه لا يغير بالضرورة من الطبيعة التوسعية للسياسة الخارجية الأمريكية التي تظل محل نقاش وانتقاد عالمي واسع.
 Loading...
Loading...



