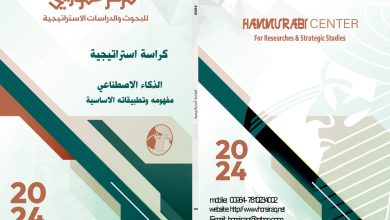الاكثر قراءةترجماتغير مصنف
الفرصة الأخيرة للغرب .. سبل بناء نظام عالمي جديد قبل فوات الوقت

بقلم: ألكسندر ستوب
ترجمة: صفا مهدي
تحرير: د. عمار عباس الشاهين
مركز حمورابي للبحوث والدراسات الإستراتيجية
شهد العالم خلال السنوات الأربع الماضية تغيرات أعظم مما شهده خلال الثلاثين عاماً السابقة، تغص خلاصة الأخبار بالصراعات والكوارث روسيا تقصف أوكرانيا و (الشرق الأوسط) يغلي والحروب تجتاح إفريقيا ومع تصاعد النزاعات يبدو أن الديمقراطيات تتراجع، عصر ما بعد الحرب الباردة انتهى وبالرغم من الآمال التي أعقبت سقوط جدار برلين لم يتوحد العالم حول تبني الديمقراطية والرأسمالية السوقية، بل على العكس القوى التي كان يُفترض أن توحد العالم – التجارة والطاقة والتكنولوجيا والمعلومات – باتت الآن تفرقه.
نعيش اليوم في عالم تتسم فوضاه بالوضوح، النظام الليبرالي القائم على القواعد الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية يواجه خطر الانهيار، فالتعاون متعدد الأطراف بدأ يتراجع أمام المنافسة متعددة الأقطاب وتبدو المعاملات الانتهازية أحياناً أهم من الدفاع عن القواعد الدولية عادت المنافسة بين القوى الكبرى حيث يحدد التنافس بين الصين والولايات المتحدة الإطار الجيوسياسي للعالم، لكنه ليس القوة الوحيدة المؤثرة. فالقوى المتوسطة الناشئة مثل البرازيل والهند والمكسيك ونيجيريا والسعودية وجنوب إفريقيا وتركيا أصبحت لاعبين محوريين، فهي تمتلك القوة الاقتصادية والنفوذ الجيوسياسي لتحويل النظام العالمي نحو الاستقرار أو الفوضى، كما أن لديها دوافع قوية للمطالبة بالتغيير إذ أن النظام متعدد الأطراف الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية لم يعكس بشكل كافٍ مكانتها العالمية ولا منحها الدور الذي تستحقه. ويتشكل اليوم صراع ثلاثي بين الغرب العالمي والشرق العالمي والجنوب العالمي، وسيحدد الجنوب العالمي ما إذا كان النظام العالمي في المرحلة المقبلة سيتجه نحو التعاون، أم الانقسام أم الهيمنة.
من المرجح أن السنوات الخمس إلى العشر المقبلة ستكون حاسمة في تشكيل النظام العالمي لعقود قادمة، فبمجرد استقرار أي نظام يميل إلى البقاء لفترة طويلة، بعد الحرب العالمية الأولى استمر النظام الجديد نحو عقدين وبعد الحرب العالمية الثانية دام النظام أربعين عاماً، والآن وبعد مرور ثلاثين عاماً على نهاية الحرب الباردة يظهر نظام جديد من الممكن أن يهيمن على العالم وهذه هي الفرصة الأخيرة للدول الغربية لإثبات قدرتها على الحوار بدل المونولوج والاتساق بدل ازدواجية المعايير والتعاون بدل الهيمنة، وإذا استمر التنافس على حساب التعاون فإن العالم يواجه خطر صراعات وفوضى أشد.
لكل دولة حتى الصغيرة مثل فنلندا القدرة على التأثير والمهم هو السعي لتعظيم هذا النفوذ واستثمار الأدوات المتاحة لدفع حلول عملية، بالنسبة لي يعني ذلك بذل كل جهد للحفاظ على النظام العالمي الليبرالي رغم أنه قد لا يكون رائجاً حالياً فالمؤسسات والمعايير الدولية تشكل الإطار الضروري للتعاون العالمي ويجب تحديثها وإصلاحها لتعكس القوة الاقتصادية والسياسية المتنامية للجنوب العالمي والشرق العالمي، لقد تحدث القادة الغربيون طويلاً عن الحاجة الملحة لإصلاح المؤسسات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة والآن بات من الضروري العمل على إعادة توازن القوة داخل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. بدون هذه الإصلاحات سيواجه النظام متعدد الأطراف خطر الانهيار، صحيح أن هذا النظام ليس مثالياً ويحتوي على عيوب جوهرية لكنه يظل أفضل من البدائل المحتملة، التي قد تتسم بانتشار دوائر النفوذ والفوضى وعدم الاستقرار.
التاريخ لم ينتهِ
بدأت دراسة العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة فورمان بالولايات المتحدة عام 1989 وفي خريف ذلك العام سقط جدار برلين، بعد فترة وجيزة توحدت ألمانيا ونجت أوروبا الوسطى والشرقية من قيود الشيوعية وتحول العالم من ثنائي القطب – حيث كان الاتحاد السوفيتي الشيوعي والسلطوي في مواجهة الولايات المتحدة الديمقراطية والرأسمالية – إلى عالم أحادي القطب، أصبحت الولايات المتحدة القوة العظمى التي لا منازع لها، بدا أن النظام الدولي الليبرالي قد انتصر. كنت أشعر بسعادة غامرة في ذلك الوقت وبدا لي وللكثيرين غيري أننا على أعتاب عصر أكثر إشراقاً، وصف عالم السياسة فرانسيس فوكوياما تلك اللحظة بـ”نهاية التاريخ” ولم أكن الوحيد الذي اعتقد أن انتصار الليبرالية كان مؤكداً، فكان من المتوقع أن تتجه معظم الدول نحو الديمقراطية والرأسمالية السوقية والحرية وأن تؤدي العولمة إلى ترابط اقتصادي متزايد وأن تتلاشى الانقسامات القديمة ويصبح العالم موحداً، وحتى عند نهاية العقد، بينما كنت أنهي درجة الدكتوراه في تكامل أوروبا في مدرسة لندن للاقتصاد بدا هذا المستقبل وشيكاً. لكن هذا المستقبل لم يتحقق فقد كانت اللحظة الأحادية القطب قصيرة العمر بعد هجمات 11 ايلول 2001 انقلب الغرب على القيم الأساسية التي كان يدعي التمسك بها وبدأ الالتزام بالقانون الدولي يُساء فهمه ويُستهدف، فشلت التدخلات التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق أما الأزمة المالية العالمية عام 2008 فقد وجهت ضربة قوية للنموذج الاقتصادي الغربي القائم على الأسواق العالمية، ولم تعد الولايات المتحدة تتحكم بالسياسة العالمية بمفردها.
برزت الصين كقوة عظمى من خلال تصاعد صناعتها وصادراتها ونموها الاقتصادي السريع وأصبح التنافس بينها وبين الولايات المتحدة محور الجغرافيا السياسية الحديثة، كما شهد العقد الأخير مزيداً من تآكل المؤسسات متعددة الأطراف وتزايد الشك والاحتكاك بشأن التجارة الحرة، وتصاعد المنافسة في مجالات التكنولوجيا. وضربت الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا في شباط 2022 النظام القديم ضربة إضافية موجعة، فقد كانت واحدة من أكثر الانتهاكات الصريحة للنظام القائم على القواعد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وبالتأكيد الأسوأ الذي شهدته أوروبا، وما جعل الأمر أكثر قسوة أن المسؤول عن ذلك كان عضواً دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أُنشئ للحفاظ على السلام، لقد كانت الدول التي يُفترض أن تحمي النظام هي نفسها التي أضعفته ودمرته.
التعددية أم التعدد القطبي؟
لم يختفِ النظام الدولي تماماً لكنه يمر بتحوّل واضح من التعددية إلى التعدد القطبي فالتعددية هي نظام للتعاون العالمي يقوم على المؤسسات الدولية والقواعد المشتركة وتطبق مبادئه على جميع الدول على حد سواء بغض النظر عن حجمها، أما التعدد القطبي فيمثل احتكاراً للقوة من قبل عدد محدود من الفواعل حيث يقوم هذا النظام على عدة أقطاب غالباً ما تكون متنافسة، وتتشكّل هيكلية العالم متعدد الأقطاب من خلال صفقات واتفاقيات بين عدد محدود من اللاعبين ما يضعف بالضرورة القواعد والمؤسسات المشتركة وقد يؤدي هذا النظام إلى سلوكيات انتهازية مؤقتة وتشكيل تحالفات متغيرة بناءً على المصالح الفورية للدول، كما يهدد التعدد القطبي بإقصاء الدول الصغيرة والمتوسطة إذ تُبرم القوى الكبرى الصفقات فوق رؤوسها في حين تقود التعددية إلى النظام والاستقرار يميل التعدد القطبي نحو الفوضى والصراع.
تتزايد اليوم التوترات بين من يدافع عن التعددية والنظام القائم على حكم القانون وبين من يروج للتعدد القطبي والسياسة القائمة على المعاملات الانتهازية، فالدول الصغيرة والمتوسطة وكذلك المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي وجمعية دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي وبلوك ميركوسور في أمريكا الجنوبية تدعم التعددية، أما الصين فهي تروّج للتعدد القطبي مع بعض مظاهر التعددية إذ تُظهر تأييدها لمجموعات متعددة الأطراف مثل مجموعة البريكس – التحالف غير الغربي الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا – ومنظمة شنغهاي للتعاون، لكن الهدف الفعلي هو دعم نشوء نظام أكثر تعددية قطبياً.
الولايات المتحدة بدورها حولت تركيزها من التعددية إلى سياسة المعاملات الانتهازية لكنها لا تزال ملتزمة ببعض المؤسسات الإقليمية مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتسعى العديد من الدول كبيرة كانت أم صغيرة إلى اتباع سياسة خارجية متعددة الاتجاهات، تهدف بالأساس إلى تنويع علاقاتها مع عدد من الفواعل بدل الانحياز لأي كتلة محددة.
تسيطر المصالح على السياسة الخارجية الانتهازية أو متعددة الاتجاهات فالدول الصغيرة على سبيل المثال غالباً ما توازن بين القوى الكبرى فتتحالف مع الصين في بعض المجالات وتتناغم مع الولايات المتحدة في أخرى مع السعي لتجنب الهيمنة من أي طرف واحد، وهذه الخيارات العملية مبنية على المصالح وهو أمر مشروع تماماً لكن هذا لا يعني تجاهل القيم التي ينبغي أن تكون أساس أي سياسة دولة، حتى السياسة الانتهازية يجب أن ترتكز على مجموعة من القيم الجوهرية مثل احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحظر استخدام القوة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولدى الدول في الغالب مصلحة واضحة في الحفاظ على هذه القيم وضمان محاسبة من ينتهكها. العديد من الدول بدأت تتخلى عن التعددية لصالح ترتيبات وصفقات مؤقتة فالولايات المتحدة على سبيل المثال تركز على الاتفاقيات الثنائية في التجارة والأعمال، وتستخدم الصين مبادرة الحزام والطريق برنامجها الضخم للاستثمار في البنية التحتية العالمية لتعزيز الدبلوماسية الثنائية والمعاملات الاقتصادية، والاتحاد الأوروبي يعقد اتفاقيات تجارة حرة ثنائية قد لا تفي أحياناً بمعايير منظمة التجارة العالمية، والمفارقة أن هذا يحدث في وقت يحتاج فيه العالم إلى التعددية أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ ونقص التنمية وتنظيم التكنولوجيا المتقدمة. بدون نظام متعدد الأطراف قوي تصبح كل الدبلوماسية قائمة على المعاملات الانتهازية، العالم متعدد الأطراف يحوّل الصالح العام إلى مصلحة ذاتية، بينما العالم متعدد الأقطاب يدور ببساطة حول المصلحة الفردية.
الواقعية القائمة على القيم في فنلندا
غالباً ما تقوم السياسة الخارجية على ثلاثة أعمدة القيم والمصالح والقوة هذه العناصر الثلاثة تصبح حاسمة بشكل خاص عندما تتغير توازنات وديناميكيات النظام العالمي، أنا أنتمي إلى دولة صغيرة نسبيًا يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة، وعلى الرغم من أن لدينا واحدة من أكبر الجيوش في أوروبا فإن دبلوماسيتنا تقوم على القيم والمصالح، أما القوة سواء كانت صلبة أو ناعمة فهي في الغالب رفاهية للاعبين الكبار الذين يستطيعون إسقاط نفوذهم العسكري والاقتصادي واضطرار الدول الصغيرة للتماشي مع أهدافهم، لكن الدول الصغيرة تستطيع أن تجد قوتها من خلال التعاون مع الآخرين فالتحالفات والمجموعات الإقليمية والدبلوماسية الذكية هي التي تمنح لاعبًا صغيرًا نفوذًا يتجاوز حجم جيشه واقتصاده وغالبًا ما تستند هذه التحالفات إلى قيم مشتركة مثل الالتزام بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
بصفتها دولة صغيرة تحد قوة إمبريالية تعلمت فنلندا أن الدولة أحيانًا تضطر إلى التنازل عن بعض القيم لحماية أخرى أو ببساطة من أجل البقاء، فالدولة تقوم على مبادئ الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي، بعد الحرب العالمية الثانية حافظت فنلندا على استقلالها بخلاف جيرانها في دول البلطيق الذين تم ضمهم إلى الاتحاد السوفيتي، لكننا فقدنا عشرة بالمئة من أراضينا لصالح الاتحاد السوفيتي بما في ذلك المناطق التي وُلد فيها والدي وأجدادي والأهم من ذلك اضطررنا للتخلي عن بعض سيادتنا، لم تستطع فنلندا الانضمام إلى المؤسسات الدولية التي شعرنا بأننا ننتمي إليها طبيعيًا مثل الاتحاد الأوروبي والناتو.
خلال الحرب الباردة كانت السياسة الخارجية الفنلندية تقوم على ما يسمى بـ”الواقعية البراغماتية” للحيلولة دون هجوم الاتحاد السوفيتي علينا مرة أخرى كما حدث في عام 1939 كان علينا المساومة على قيمنا الغربية، هذه الحقبة من تاريخ فنلندا التي أطلق عليها مصطلح “الفنلندة” في العلاقات الدولية ليست من أكثر الفترات التي نفخر بها لكننا نجحنا في الحفاظ على استقلالنا وقد جعلتنا هذه التجربة حذرين من أي احتمال لتكرارها وعندما يقترح البعض أن تكون “الفنلندة” حلاً لإنهاء الحرب في أوكرانيا فأنا أعارض ذلك بشدة إذ أن مثل هذا السلام سيأتي بتكلفة باهظة تعادل عمليًا التنازل عن السيادة والأراضي.
بعد نهاية الحرب الباردة تبنت فنلندا مثل العديد من الدول الأخرى فكرة أن قيم الغرب العالمي ستصبح المعيار السائد – ما أسميه بـ”المثالية القائمة على القيم”، وقد أتاح هذا التوجه لفنلندا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995، في الوقت نفسه ارتكبت فنلندا خطأً جسيمًا إذ قررت طواعيةً البقاء خارج حلف الناتو (وللتوضيح لقد كنت من المدافعين المتحمسين عن عضوية فنلندا في الناتو منذ ثلاثين عامًا)، بعض الفنلنديين كانوا يعتقدون بشكل مثالي أن روسيا ستصبح ديمقراطية ليبرالية في المستقبل لذا كان الانضمام للناتو غير ضروري وآخرون خشوا من رد فعل سلبي من روسيا وفئة ثالثة اعتقدت أن فنلندا تساهم في الحفاظ على التوازن – وبالتالي السلام – في منطقة بحر البلطيق بالبقاء خارج الحلف. جميع هذه المبررات تبين فيما بعد أنها كانت خاطئة وقد عدّلت فنلندا موقفها وفقًا لذلك فانضمت إلى الناتو بعد الهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا وكان هذا القرار نتاجًا للقيم والمصالح معًا، لقد تبنت فنلندا ما أسميه بـ”الواقعية القائمة على القيم” الالتزام بمجموعة من القيم العالمية المستندة إلى الحرية والحقوق الأساسية والقواعد الدولية مع احترام الواقع المتنوع للثقافات والتاريخ العالمي، يجب على الغرب العالمي أن يظل متمسكًا بقيمه لكنه عليه أن يدرك أن مشاكل العالم لن تُحل بالتعاون مع الدول الشبيهة فقط.
قد تبدو الواقعية القائمة على القيم متناقضة لكنها ليست كذلك فقد ظهرت نظريتان مؤثرتان بعد الحرب الباردة تبدو وكأنهما تضعان القيم العالمية في مواجهة تقييم أكثر واقعية للانقسامات السياسية، فقد رأت أطروحة فرانسيس فوكوياما حول “نهاية التاريخ” أن انتصار الرأسمالية على الشيوعية يبشر بعالم ليبرالي وسوقي أكثر، بينما توقّع عالم السياسة صموئيل هنتنغتون في رؤيته لـ”صراع الحضارات” أن خطوط الانقسام الجيوسياسية ستنتقل من الاختلافات الأيديولوجية إلى الثقافية، في الواقع يمكن للدول أن تستفيد من كلا الفهمين عند صياغة استراتيجياتها في النظام العالمي المتغير اليوم.
عند صياغة السياسة الخارجية يمكن لحكومات الغرب العالمي أن تحافظ على إيمانها بالديمقراطية والأسواق دون الإصرار على أنها قابلة للتطبيق عالميًا، ففي أماكن أخرى قد تسود نماذج مختلفة وحتى ضمن الغرب نفسه، قد تجعل الحاجة إلى الأمن والدفاع عن السيادة من الصعب الالتزام التام بالمبادئ الليبرالية.
ينبغي أن تسعى الدول إلى نظام عالمي تعاوني قائم على الواقعية المبنية على القيم يحترم سيادة القانون والاختلافات الثقافية والسياسية على حد سواء، بالنسبة لفنلندا يعني ذلك التواصل مع دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لفهم مواقفها بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا وغيرها من الصراعات الجارية، كما يعني خوض حوارات عملية ومتساوية بشأن القضايا العالمية المهمة مثل نقل التكنولوجيا والموارد الطبيعية وتغير المناخ.
مثلث القوة العالمي
يتشكل التوازن العالمي للقوة اليوم من ثلاث مناطق رئيسية (الغرب العالمي، والشرق العالمي، والجنوب العالمي). “الغرب العالمي” يضم نحو 50 دولة بقيادة الولايات المتحدة ويشمل أساسًا الدول الديمقراطية السوقية في أوروبا وأمريكا الشمالية، إضافة إلى حلفاء بعيدين مثل أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، هذه الدول سعت تاريخيًا للحفاظ على نظام دولي متعدد الأطراف قائم على القواعد حتى مع اختلافها حول كيفية صيانته أو إصلاحه أو إعادة ابتكاره.
(الشرق العالمي) يضم نحو 25 دولة بقيادة الصين ويشمل شبكة من الدول الحليفة مثل إيران وكوريا الشمالية وروسيا، التي تسعى إلى تعديل النظام الدولي القائم أو استبداله، تجمع هذه الدول مصلحة مشتركة واحدة وهي تقليص نفوذ الغرب العالمي.
(الجنوب العالمي) يضم غالبية دول العالم النامية ومتوسطة الدخل من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب وجنوب شرق آسيا، ويشمل حوالي 125 دولة تمثل غالبية سكان العالم، العديد منها عانى من الاستعمار الغربي وكان مسرحًا للحروب بالوكالة خلال الحرب الباردة، ويضم الجنوب العالمي دولًا متوسطة القوة أو “دول التأرجح” مثل البرازيل والهند وإندونيسيا وكينيا والمكسيك ونيجيريا والسعودية وجنوب أفريقيا، حيث يدعم النمو السكاني والتنمية الاقتصادية واستخراج الموارد الطبيعية صعودها على الساحة الدولية.
الصراع بين الغرب والشرق العالميين يدور على كسب دعم الجنوب العالمي فالجنوب يمتلك بطاقة التصويت الحاسمة في تحديد اتجاه النظام العالمي الجديد، ولكن لا يمكن للغرب جذب الجنوب بمجرد مدحه للحرية والديمقراطية بل يجب أن يقدم استثمارات اقتصادية ومشاريع تنموية ويمنح الجنوب صوتًا ومشاركة حقيقية في صناعة القرار، وبالمثل لن يكسب الشرق العالمي النفوذ الكامل عبر الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات المباشرة فالولاء لا يُشترى بسهولة كما أشارت الهند ودول الجنوب الأخرى التي تؤكد على استقلالية مواقفها.
الواقعية القائمة على القيم هي ما يحتاجه القادة الغربيون والشرقيون اليوم فالسياسة الخارجية ليست مسألة ثنائية بل تتطلب خيارات يومية تمزج بين القيم والمصالح، على سبيل المثال هل تشتري أسلحة من دولة تنتهك القانون الدولي؟ هل تمول دولة ديكتاتورية تحارب الإرهاب؟ هناك قيم أساسية غير قابلة للتفاوض منها حماية الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان وحماية الأقليات والحفاظ على الديمقراطية واحترام سيادة القانون، هذه القيم يجب أن تشكل العمود الفقري للغرب العالمي لا سيما في مخاطبته للجنوب العالمي مع الاعتراف بأن ليس كل الدول تشترك في هذه القيم.
تهدف الواقعية القائمة على القيم إلى تحقيق توازن بين المبادئ والمصالح مع إعطاء الأولوية للقيم الأساسية مع إدراك حدود قدرة الدولة عندما تكون مصالح السلام والاستقرار والأمن على المحك، يظل النظام الدولي القائم على القواعد والمدعوم بمؤسسات دولية فعالة أفضل وسيلة لمنع التنافس من التحول إلى صدام، ولكن مع تراجع فعالية هذه المؤسسات يجب على الدول تبني نهج أكثر واقعية يأخذ في الاعتبار الاختلافات الجغرافية والتاريخية والثقافية والدينية ودرجات التنمية الاقتصادية، وإذا أرادت دول العالم التأثير في حقوق المواطنين والممارسات البيئية وحوكمة الرشيد فعليها أن تقود بالقدوة وتقدم الدعم بدلًا من المحاضرات. تبدأ الواقعية القائمة على القيم بالاحترام المتبادل وفهم الاختلافات وتعتمد على شراكات متكافئة بدلًا من تصورات تاريخية مسبقة عن العلاقات بين الغرب والشرق والجنوب، الطريق نحو المستقبل يكمن في التركيز على المشاريع المشتركة الكبرى مثل البنية التحتية والتجارة والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. تواجه جهود بناء نظام عالمي متوازن يعترف بالاختلافات ويتيح للدول وضع مصالحها الوطنية ضمن إطار تعاوني تحديات كبيرة، ولكن تكلفة الفشل هائلة كما يذكر التاريخ، لا سيما النصف الأول من القرن العشرين. عدم اليقين جزء من طبيعة العلاقات الدولية لا سيما خلال الانتقال من عصر إلى آخر المفتاح هو فهم أسباب التغيير وكيفية التعامل معه، إذا عاد الغرب العالمي إلى أساليب الهيمنة القديمة أو الغطرسة المطلقة فسيفشل أما إذا أدرك أهمية الجنوب العالمي في النظام الدولي القادم فقد يتمكن من إقامة شراكات قائمة على القيم والمصالح معًا قادرة على مواجهة التحديات الكبرى، توفر الواقعية القائمة على القيم للغرب المجال للتنقل بذكاء في هذا العصر الجديد من العلاقات الدولية.
عوالم قادمة
لقد ساعدت مجموعة من المؤسسات التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية العالم على اجتياز أسرع مراحل تطوره كما حافظت على فترة استثنائية من السلام النسبي لكنها اليوم تواجه خطر الانهيار، بقاء هذه المؤسسات أمر حيوي إذ إن عالمًا يقوم على التنافس دون تعاون سيؤدي حتمًا إلى الصراع ولكن لكي تصمد يجب أن تتغير فالكثير من الدول تفتقر إلى القدرة على التأثير في النظام الحالي، وإذا لم تحدث تغييرات فسوف تنسحب منه وهو أمر مفهوم ومنطقي فالنظام العالمي الجديد لن ينتظر. ويمكن تصور ثلاثة سيناريوهات محتملة خلال العقد القادم الأول هو استمرار الفوضى الحالية حيث تبقى عناصر من النظام القديم لكن الالتزام بالقواعد والمؤسسات الدولية سيكون انتقائيًا ويعتمد أساسًا على المصالح وليس على القيم الجوهرية مع محدودية القدرة على معالجة التحديات الكبرى، بينما ستصبح تسوية النزاعات صعبة إذ ستكون معظم اتفاقيات السلام تعاملية وتفتقر إلى السلطة التي يمنحها توقيع الأمم المتحدة. والثاني هو انهيار النظام الدولي الليبرالي حيث تستمر المؤسسات والقواعد الدولية في التآكل حتى ينهار النظام القائم فينزلق العالم نحو الفوضى بلا مركز واضح للسلطة، مع عجز الدول عن مواجهة الأزمات الحادة مثل المجاعات والأوبئة والنزاعات ويمتلئ الفراغ الدولي بالقادة المستبدين والميليشيات والفاعلين غير الحكوميين ما يزيد احتمالات اندلاع حروب أوسع، ويصبح الاستقرار والتوقع الاستثناء وليس القاعدة ويصعب التوسط في السلام. أما السيناريو الثالث فهو إمكانية إعادة توازن القوى العالمية بحيث ينتج عن التوازن الجديد بين الغرب والشرق والجنوب العالمي نظام عالمي متوازن يمكن للدول من خلاله مواجهة التحديات الكبرى عبر التعاون والحوار بين الأطراف المتساوية، ويحد هذا التوازن من التنافس ويدفع العالم نحو تعاون أكبر في قضايا المناخ والأمن والتكنولوجيا وهي تحديات لا يمكن لأي دولة حلها بمفردها مع سيادة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بما يضمن اتفاقات عادلة ودائمة شريطة إصلاح المؤسسات الدولية. ويبدأ الإصلاح من القمة أي الأمم المتحدة عبر ثلاثة تغييرات رئيسية تعزز دور المنظمة وتمكن الدول التي تشعر بعدم امتلاكها للقدرة على التأثير: تمثيل جميع القارات في مجلس الأمن بشكل دائم وإلغاء حق النقض الفردي الذي يعرقل عمل المجلس اليوم وتعليق عضوية أي دولة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة كما كان ينبغي أن يُطبق على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا مع اتخاذ القرار عبر الجمعية العامة لضمان عدم وجود معايير مزدوجة. كما تحتاج المؤسسات الاقتصادية العالمية إلى تحديث فمنظمة التجارة العالمية التي عانت لسنوات من شلل آلية تسوية النزاعات لا تزال ضرورية فمع أن أكثر من 70% من التجارة العالمية تتم وفق مبدأ “الأمة الأكثر تفضيلًا” فإن انتهاك القواعد يضر بالجميع لذا يجب أن يؤدي الإصلاح إلى مزيد من الشفافية ومرونة أكبر في اتخاذ القرارات وينبغي تنفيذ هذه التغييرات بسرعة لتجنب فقدان المصداقية، وفي هذا السياق يكمن التحدي أمام الغرب في ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل دعم النظام متعدد الأطراف الذي ساهمت في بنائه واستفادت منه كثيرًا لا سيما بعد انسحابها من مؤسسات واتفاقيات رئيسية واتباعها نهجًا تجاريًا أكثر انفرادًا بينما يظل التحدي أمام الشرق مرتبطًا بكيفية إدارة الصين لدورها الدولي سواء عبر ملء الفراغات التي تركتها الولايات المتحدة في مجالات التجارة والتعاون المناخي والتنمية أو تعزيز نفوذها في المؤسسات الدولية أو حتى اتخاذ خطوات أكثر عدوانية في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان متخلية عن استراتيجيتها التقليدية في الانتظار والتحفظ، إن هذه المرحلة الانتقالية تحمل فرصًا كبيرة لإعادة بناء النظام العالمي على أساس من التعاون المتوازن لكن النجاح يتطلب رؤية واضحة التزامًا بالقيم الأساسية ومرونة في التعامل مع مصالح الدول المختلفة لضمان نظام عالمي أكثر استقرارًا وعدالة.
يالطا أم هلسنكي؟
يمكن أن يصمد نظام دولي مثل ذلك الذي أسسه الإمبراطورية الرومانية لقرون أحيانًا لكن في الغالب تدوم الأنظمة لبضعة عقود فقط، تشكل الحرب الروسية العدوانية على أوكرانيا بداية مرحلة جديدة في النظام العالمي فهي تمثل للشباب اليوم لحظة مماثلة لتلك التي عاشها العالم في 1918 و1945 و1989، عند هذه المفترقات التاريخية قد يسلك العالم طريقًا خاطئًا كما حدث بعد الحرب العالمية الأولى حين عجزت عصبة الأمم عن احتواء التنافس بين القوى العظمى مما أدى إلى حرب عالمية دامية أخرى، وفي المقابل يمكن للدول أن تتخذ المسار الصحيح جزئيًا أو كليًا كما حصل بعد الحرب العالمية الثانية مع تأسيس الأمم المتحدة إذ حافظ هذا النظام بعد الحرب على السلام بين القوتين العظميين في الحرب الباردة الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة رغم أن الاستقرار النسبي تحقق بتكلفة عالية على الدول التي فرض عليها الخضوع أو عانت خلال النزاعات بالوكالة، كما أن الأسس التي وضعها نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية ساهمت أيضًا في خلق بعض الاختلالات الحالية.
في عام 1945 اجتمع المنتصرون في الحرب في يالطا بشبه جزيرة القرم حيث وضع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين نظامًا لما بعد الحرب قائمًا على مناطق النفوذ، وأفرز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منصة لحل الخلافات بين القوتين العظميين لكنه لم يمنح مساحة كبيرة للدول الأخرى، في يالطا قررت الدول الكبرى مصير الدول الصغيرة من دون مشاركتها وهو خطأ تاريخي يجب تصحيحه اليوم.
على النقيض من ذلك شكل مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا عام 1975 في هلسنكي نموذجًا مختلفًا إذ اجتمعت 32 دولة أوروبية بالإضافة إلى كندا والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة لوضع هيكل أمني أوروبي قائم على قواعد ومعايير تطبق على الجميع، تم الاتفاق على مبادئ أساسية تحكم سلوك الدول تجاه مواطنيها وبعضها البعض وكان إنجازًا استثنائيًا في مجال التعددية في زمن التوترات الكبرى، وساهم بشكل فعال في نهاية الحرب الباردة. كانت نتائج يالطا متعددة الأقطاب بينما مثلت هلسنكي نموذجًا للتعددية الحقيقية، واليوم يواجه العالم خيارًا مهمًا وأرى أن نموذج هلسنكي هو الطريق الأمثل للمضي قدمًا، فالخيارات التي نتخذها خلال العقد القادم ستحدد ملامح النظام العالمي في القرن الحادي والعشرين.
الدول الصغيرة مثل بلدي ليست مجرد مراقب فالنظام الجديد سيتشكل عبر القرارات التي يتخذها قادة الدول الكبرى والصغرى على حد سواء سواء كانوا ديمقراطيين أو استبداديين أو بينهما، وفي هذا السياق تقع مسؤولية خاصة على عاتق الغرب العالمي بوصفه مهندس النظام السابق وما زال اقتصاديًا وعسكريًا التحالف العالمي الأكثر قوة، الطريقة التي نمارس بها هذه المسؤولية اليوم هي التي ستحدد نجاحنا، إنها فرصتنا الأخيرة.
* Alexander Stubb, The West’s Last Chance How to Build a New Global Order Before It’s Too Late, FOREIGN AFFAIRS, December 2, 2025.
 Loading...
Loading...