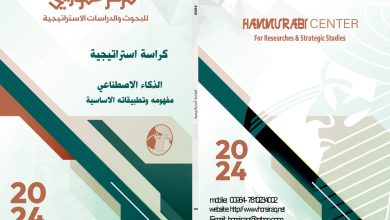الاكثر قراءةتحليلات و آراءغير مصنف
السيادة الشعبية والسيادة الدينية: جدل الشرعية ومأزق الاعتراف في النظام الدولي

بقلم: حنين محمد الوحيلي/ باحثة في مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية
في عالم يفترض أنه تجاوز الإملاءات الإمبريالية وتبنى مبادئ السيادة والمساواة بين الدول، ما زالت الشرعية السياسية تمنح وتسحب بناءً على تصورات انتقائية تهيمن عليها الرؤية الليبرالية الغربية. فالديمقراطية بمفهومها الإجرائي المستورد أصبحت المعيار شبه الوحيد للاعتراف الدولي، في حين تحاصر النماذج التي تستند إلى مرجعية دينية أو تستمد شرعيتها من تصور مختلف للسلطة والسيادة.
وبينما ينظر للسيادة الشعبية كذروة “التحرر السياسي” تقدم “السيادة الدينية” في الإعلام الغربي والسرديات الدولية على أنها نقيض الحداثة وعقبة أمام حرية الشعوب. هذا التوصيف لا يفتقر فقط إلى الدقة بل يكشف عن خلل بنيوي في فهم تعددية المرجعيات السياسية والثقافية، ويضع النظام الدولي في مواجهة مع واقع عالمي متنوع لم يعد قابلاً للتنميط تحت سقف فكري واحد.
هذا المقال لا يسعى إلى المفاضلة بين نماذج الحكم بل إلى مساءلة المعايير الدولية التي تقنن الشرعية وتوزع الاعتراف وفق اعتبارات سياسية أكثر من كونها مبدئية. كما يحاول تفكيك التصور المسبق عن السيادة الدينية بوصفها قيداً على الشعوب، ويعيد طرحها كمفهوم قابل للتحليل والنقد لا للرفض الفوري.
انتقائية النظام الدولي في الاعتراف بشرعية الحكم
رغم تعدد أنماط الحكم في العالم من الملكيات المطلقة إلى الأنظمة العسكرية ومن الديمقراطيات التمثيلية إلى الأنظمة المختلطة، يصر النظام الدولي الحديث على تقديم السيادة الشعبية “بمعناها الليبرالي الغربي” كنموذج وحيد للشرعية السياسية. وفي المقابل تعامل السيادة الدينية بريبة باعتبارها تعارض حرية الإرادة الشعبية أو تشكل تهديداً لقيم “النظام العالمي القائم على حقوق الإنسان” كما تعرفها المؤسسات الغربية.
لكن المفارقة أن هذا التصنيف لا يطبق على الجميع بالتساوي. فأنظمة ملكية لا تجري انتخابات أو تجريها ضمن إطار ضيق للغاية تحظى باعتراف دولي واسع، لا لكونها ديمقراطية بل لأنها منسجمة مع المصالح الدولية أو لا تمثل تحدياً أيديولوجياً للنظام القائم. في المقابل تعاقب أنظمة دينية مثل الجمهورية الإسلامية في إيران أو حكومة طالبان أو حتى حركة حماس، رغم امتلاكها أشكالاً من الشرعية الداخلية سواء كانت انتخابية أو عقدية.
خذ على سبيل المثال الكيان الصهيوني الذي يصور كديمقراطية نموذجية رغم أنه يقوم على احتلال عسكري ونظام فصل عنصري، بينما تقصى حركة حماس من المعادلة الدولية رغم فوزها في انتخابات نزيهة عام 2006، لأنها تتبنى خطاباً دينياً مقاوماً لا ينسجم مع المنظومة الغربية.
هذه الانتقائية لا تعبر عن معيار قانوني ثابت بل عن تفضيل أيديولوجي مبني على الهيمنة السياسية والاقتصادية. فالاعتراف الدولي ليس مجرد عملية فنية أو بيروقراطية بل هو عملية محملة باعتبارات استراتيجية، تحدد من يسمح له بأن يكون دولة ذات سيادة ومن يبقيه المجتمع الدولي في حالة “وصاية” أو “مراقبة”.
السيادة الدينية نموذج إنساني قديم أم تهديد حديث؟
رغم الصورة النمطية التي تقدم عن السيادة الدينية باعتبارها نقيضاً للحرية السياسية، إلا أن المراجعة التاريخية والفكرية لتطور هذا المفهوم تظهر أنه غالباً نشأ بوصفه قيداً على السلطة لا تعزيزاً لها. فحين تنشأ أنظمة الحكم المطلقة دون مرجعية تضبطها يتحول الإنسان إلى مشرع مطلق، ويصبح القانون ذاته خاضعاً لتقلبات القوة أو رغبات الجماعة. ولهذا شكل مفهوم السيادة الإلهية في العديد من التجارب السياسية محاولة لصياغة مرجعية تعلو على الحاكم والمحكوم معاً، وتخضع الجميع لمنظومة من القيم الثابتة.
في السياق الإسلامي اتخذ هذا المفهوم صيغاً متعددة، لكنه ظل مرتبطاً بفكرة أن الحكم ليس حقاً شخصياً ولا يكتسب بالقوة أو الإجماع وحده، بل يجب أن يستمد من مصدر أعلى يضمن العدل ويربط السلطة بالمسؤولية أمام الله لا فقط أمام الناس. هذه الفكرة كانت أساساً لكثير من المواقف النقدية التي واجهت السلطة بعد استشهاد النبي محمد (ص)، حين برز سؤال من له الحق في الحكم؟ ومن يضبط الحاكم إن أخطأ؟ وبينما ذهب التيار السياسي العام نحو إقرار مبدأ الشورى، تبلور موقف مغاير يرى أن السيادة لله تعني عدم قابلية السلطة للاحتكار أو التوريث أو التفاهمات القبلية، بل لا بد أن تخضع لتعيين إلهي يضمن عدالتها ومشروعيتها.
هذا الموقف لم يكن صراعاً على السلطة بل رؤية أخلاقية أرادت أن تربط الحكم بالحق لا بالعدد، وبالشرع لا بالمزاج العام. وقد تطورت لاحقاً في الفكر الشيعي الإمامي إلى تصور واضح حول الإمامة والنيابة، حيث لا تمنح الشرعية لحاكم مهما كانت شعبيته إن لم يكن مؤتمناً على الدين وملتزماً بحدود الله. ومن هنا ظهرت صيغة حديثة “كما في نظرية ولاية الفقيه” ترى أن غياب المعصوم لا يعني غياب المرجعية بل يتطلب قيام سلطة مشروطة تمثل روح الشريعة وتحفظ مصالح الأمة دون أن تستبد باسمها.
هذا النموذج إذ يعيد ضبط العلاقة بين الدين والسياسة لا يقصي إرادة الناس بل يؤطرها، ويمنعها من أن تستخدم كأداة لتبرير الظلم أو التطبيع مع الفساد أو التبعية. بل إن بعض التجارب التي تبنت هذا النموذج كما في لبنان أو اليمن أو العراق، قدمت نماذج مقاومة قائمة على روح العدالة والكرامة لا على القسر أو القمع. وهو ما يبرز البعد القيمي للسيادة الدينية لا كقيد على الأمة بل كدرع يحميها من الاستبداد الخارجي والداخلي معاً.
وإذا توسعنا في الأمثلة التاريخية والمعاصرة، نجد أن السيادة الدينية كمرجعية للحكم ليست حكراً على الإسلام بل شكلت أساساً لشرعية دول متنوعة حظيت بقبول داخلي ودولي، رغم تناقضها مع النموذج الليبرالي:
-
إثيوبيا المسيحية: حيث صمدت الإمبراطورية (1270-1974) بشرعية دينية أرثوذكسية ضد الاستعمار الأوروبي، ولا تزال الكنيسة تمثل ضمير الأمة حتى اليوم.
-
الفاتيكان الكاثوليكي: الدولة الثيوقراطية الوحيدة المعترف بها دولياً، والتي ترفض الديمقراطية لكنها تحظى بمكانة دبلوماسية فريدة.
-
بوتان البوذية: التي تبني سياستها على “مؤشر السعادة الوطنية” المستمد من القيم الدينية، وتقدم في الغرب كـ “يوتوبيا روحية”.
هذه النماذج تثبت أن قبول النظام الدولي للسيادة الدينية أو رفضها لا يعتمد على طبيعتها الدينية، بل على مدى انسجامها مع الهيمنة الغربية. فبوتان والفاتيكان تقبلان لأنهما لا تهددان النظام الليبرالي بينما ترفض نماذج إسلامية مماثلة لمجرد تحديها الهيمنة السياسية الغربية.
تناقضات الاعتراف الدولي وصدام المرجعيات
رغم أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها، إلا أن الممارسة الواقعية للاعتراف السياسي تكشف عن شبكة معقدة من الانتقائية والتفضيل الأيديولوجي. فالاعتراف لا يمنح تلقائياً بمجرد قيام الدولة أو وجود مؤسسات شرعية داخلية، بل يخضع في كثير من الحالات لمدى توافق النموذج السياسي مع المنظومة الليبرالية الغربية خصوصاً فيما يتعلق بمصدر السيادة.
في هذا السياق تواجه الأنظمة التي تتبنى السيادة الدينية مأزقاً متكرراً، فهي تدان مسبقاً حتى قبل اختبارها سياسياً، لأنها لا تستمد شرعيتها من “إرادة الشعب” بوصفه المرجع الأعلى بل من تصور ميتافيزيقي يرى في الله مصدر السلطة، وفي القانون الإلهي ضابطاً للحكم. هذا التوجه يعد في نظر المنظومة الغربية خطراً على القيم العالمية التي تم بناء النظام الدولي الحديث عليها بما فيها العلمانية والنسبية الأخلاقية والمركزية الإنسانية.
لكن الممارسة الواقعية تكشف عن ازدواجية صارخة فأنظمة استبدادية لا تجري انتخابات ولا تتيح حرية التعبير تعامل كحلفاء شرعيين، فقط لأنها لا تتحدى التوازنات الدولية أو لأنها تلعب دوراً وظيفياً في المعسكر الغربي. في المقابل تقاطع أنظمة وحركات نابعة من مجتمعاتها وتتمتع بقبول داخلي لأنها ترفض النموذج السياسي الغربي أو تجاهر بعدائها للهيمنة الأمريكية. يكافأ القبول ويعاقب التمرد، لا بناءً على سلوك الحكم بل بناءً على مرجعيته.
هذا التصادم بين السيادتين لا يبقى نظرياً بل ينتج حالة اضطراب مزمن في النظام الدولي، لأنه يعكس أزمة تعريف الشرعية ذاتها، هل هي الإرادة الشعبية مهما كانت نتائجها؟ أم المرجعية الدينية بشرط تحقيق العدل؟ أم رضا القوى الكبرى؟ وبينما تمارس الأمم الغربية سلطة الاعتراف كامتياز سياسي، يبرز سؤال مهم من يملك حق نفي أو إثبات شرعية سلطة اختارها شعبها أو رضيت بها نخبه على أسس دينية؟
النتيجة أن النظام الدولي بات يدار كمنظومة مغلقة لا تقبل إلا النماذج التي تشبهها، وتخشى من كل تجربة تعيد ترتيب العلاقة بين الدين والسياسة بطريقة مختلفة. وهذا ما يجعل الاعتراف السياسي ليس مجرد إجراء قانوني بل أداة ضبط أيديولوجي تستخدم للحد من استقلالية الشعوب وتنوع مرجعياتها.
فالقبول الدولي لأنظمة كـالفاتيكان (ثيوقراطية صريحة) أو بوتان (مرجعية بوذية في الدستور)، مقابل وصم أنظمة إسلامية مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو حركات كحماس بـأنها حكومات “تهدد السلم الدولي” أو حكومات “غير شرعية”، يكشف أن المعيار ليس دينياً ولا أخلاقياً بل جيوسياسي. وهذا ما يؤكد أن الرفض الغربي للسيادة الدينية الإسلامية ليس رفضاً للدين في السياسة مبدئياً، بل رفض لاستقلالية القرار السياسي الخارج عن الهيمنة الليبرالية. فالدين مقبول عندما يكون تابعاً وغير مقبول عندما يكون مشروعاً تحررياً.
ففي عالم يزعم احترام التعددية تبدو السلطة الدينية وكأنها الاستثناء الوحيد غير المرحب به في هندسة الشرعية السياسية. وبينما تقبل أنظمة لا تمت بصلة للديمقراطية أو الحقوق فقط لأنها لا تصطدم بالرؤية الغربية، تقصى تجارب دينية نابعة من عمق مجتمعاتها لأنها تجرؤ على إعادة تعريف مصدر السلطة خارج النسق الليبرالي.
هذا لا يعني أن كل نظام ديني هو بالضرورة عادل ولا أن كل نظام شعبي هو بطبيعته حر. لكنه يكشف عن أزمة أعمق في النظام الدولي، عجزه عن الاعتراف بشرعية لا تشبهه وخوفه من نموذج لا يدين له بالمرجعية. فالسيادة سواء كانت شعبية أو دينية ليست الخطر بحد ذاتها بل استقلالها الفكري عن مركز الهيمنة، وقدرتها على إنتاج تصور مختلف للإنسان والسلطة والمجتمع.
الاعتراف إذاً لم يعد فعلاً تقنياً بل حكماً مسبقاً على القيم والمشاريع. وبين سيادة تؤمن أن الإنسان مشرع نفسه وأخرى ترى أن الحكم لا يستقيم إلا بقيود من خارج الإنسان، تبقى الأسئلة مفتوحة من يملك حق تعريف الحرية؟ ومن يحدد معايير الشرعية؟ وهل نحن أمام نظام دولي أم نظام أيديولوجي يتخفى خلف لغة القانون؟
قد لا نجد جواباً واحداً لكن الواضح أن رفض السلطة الدينية ليس دفاعاً عن الشعوب، بل دفاعاً عن سردية واحدة تخشى التعدد وتخاف من أي حق لا يولد من داخلها.
 Loading...
Loading...